الصهاينة العرب واليهود.. وشرط التصدي الفلسطيني
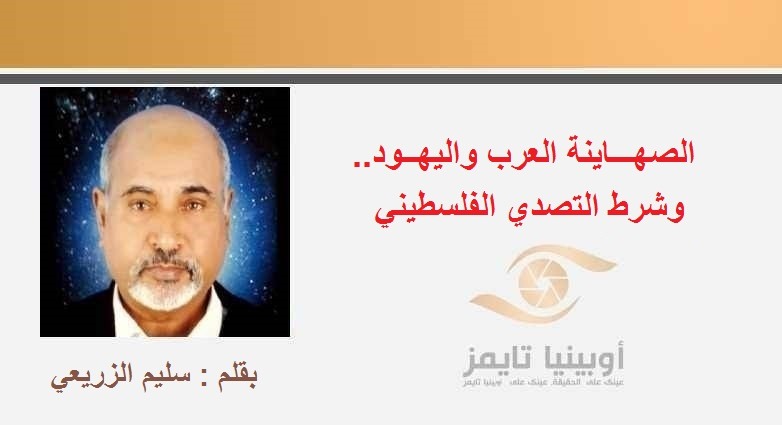
سليم يونس
فيما تتزايد العواصم العربية التي تتماهى في رواية الكيان الصهيوني عن الحقوق الفلسطينية حتى في حدها الأدنى، بل وتتجاهل سياساته الفاشية تجاه الشعب الفلسطيني، وممارساته ضد القدس والأقصى، بات المشهد الفلسطيني في أسوأ حالة وصل إليها من انقسام سياسي وفقدان الرؤية السياسية الفلسطينية الجامعة في ظل اصطفاف دول عربية إلى جانب المحتل ليكونوا موضوعيا في خندق الاحتلال.
هشاشة الواقع الفلسطيني
ومع أن هذا الأمر هو حِمْل إضافي على كاهل الفلسطينيين بكل ما يحمله من تداعيات، إلا أن الأساس في استمرار الصراع مع الاحتلال وتجاوز هذا التواطؤ لبعض العرب الذي أصبح مكشوفا بعد أن كان يجري خلف الستار، بل ويتباهون به، إنما يتعلق بمهمة التحرير والعودة التي كانت وستبقى فعلا فلسطينيا بامتياز.
لكن الحالة الفلسطينية التي تمثلها قوى سياسية وأحزاب فلسطينية، لا تدعو إلى التفاؤل في هذه اللحظة وبالطبع بعيدا عن ثابت التفاؤل الاستراتيجي المتكئ على حتمية التحرير والعودة بصرف النظر عن مرارة شرط اللحظة، بعد أن أصبح فيها التحالف العربي مع كيان العدو الصهيوني أمر واقعا للأسف.
وكان من الواجب على القوى الفلسطينية التي تبدو عاجزة ومتشظية أمام هذا الواقع الذي يتشكل بين الدول العربية والكيان الصهيوني، الذي هو بالتأكيد ليس في صالح النضال الفلسطيني من أجل انتزاع حقوقه المشروعة، أن ترقى إلى مستوى المسؤولية بعيدا عن الروح الحلقية، وتبدأ في التو إعادة الاعتبار لمؤسسات منظمة التحرير ولمفهوم الوحدة، التي هي كلمة السر في مواجهة استهداف القضية الوطنية الفلسطينية من قبل الصهاينة اليهود والصهاينة العرب.
سؤال الوحدة الفلسطينية
والسؤال هنا هو؛ ما الذي يمنع من تحقيق الوحدة وتشكيل قيادة واحدة للشعب الفلسطيني في مواجهة هذا التحالف الجديد الصهيوني العربي؟ وإذا كان صحيحا أن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل نظريا على الأقل هذه القيادة، إلا أن عملية الاستحواذ والهيمنة أفرغت هذه المنظمة من محتواها الكفاحي كمشروع تحرير بعد خطيئة أوسلو، وهيمنة حركة فتح عليها لتصبح تابعة للسلطة التي أفرزها اتفاق أوسلو وأداة تمرير لرؤية طرف فلسطيني بات أسيرا لوهم الحل السياسي، بكل ما ترتب على ذلك من إبراز دور السلطة وتبهيت وتراجع دور منظمة التحرير التي هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والإطار الذي يجمع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية باستثناء قوى الإسلام السياسي التي تأخرت مشاركتها في العمل الكفاحي الفلسطيني حتى عام 1988.
وإنه يصبح نوعا من الهروب إلى الإمام الحديث عن الوحدة في غياب قوى مقرره في الواقع سواء اتفقت أو اختلفت معها، مع إدراك ووعي دورها السلبي الذي أنتج الانقلاب في غزة عام 2007، ومخاطر فكرها الإقصائي، لكنها مع كل ذلك، هي واقع موضوعي، لا يتعلق برغبات هذا الطرف أو ذاك.
ومن ثم فإن شرط الوحدة لمواجهة حالة الانهيار العربي وهزال الحالة الفلسطينية التي ما تزال قيادتها تراهن على حل سياسي لم يبق من أساس موضوعي له، يزكي ذلك أن وقائع ممارسات الاحتلال، تدحض هذا الوهم المستمر منذ خطيئة أوسلو، فيما تضفي حالة الانقسام وانعدام الثقة والحروب الإعلامية البينية بين فتح وحماس بشكل أساسي، وحالة النفي المتبادل رغم ضجيج صوت الوحدة، كون كل طرف يكيّف ترجمة مفهوم الوحدة انطلاقا من رؤيته، متجاهلا حالة التنوع الفكري والسياسي في الواقع الفلسطيني، الذي لا يمكن قسمته على اثنين، هو في فهم ميزان القوى القائم داخليا وخارجيا، وتخلي فتح وحماس عن عقلية الهيمنة والاستحواذ والاستعلاء على الآخر، والبحث عن وحدة من أجل التحرير ولم شتات الشعب الفلسطيني، لا وحدة لتقاسم النفوذ والمصالح في وطن هو تحت الاحتلال!!
القواسم المشتركة
ولذلك فإن على من يريد مواجهة الانهيار السياسي العربي، أن يعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني ليواجه المشروع الصهيوني ويمكنه ذلك إذا ما سخرت ممكنات القوة الفلسطينية والعربية التي لم تصب بفيروس الصهيونية، بأن لا يسمح لأحد أن يضع أحدا في جيبه؛ سواء حماس أو فتح أو أي فصيل آخر وذلك عبر التسليم بأن التناقض الفكري والسياسي حقيقة قائمة بين الأطراف الفلسطينية وأن كل طرف يسعى من أجل تغليب مصالحة، ولكن حل ذلك ولو مرحليا، ينطلق من وضع قضايا الخلاف الفكرية والاجتماعية جانبا، والتوحد خلف القواسم السياسية والكفاحية المشتركة وهي كثيرة وتؤسس لبرنامج كفاحي يتكئ على حالة شعبية تعيش حالة اشتباك مستمر مع الاحتلال.
لكن هذا البرنامج يعني رفع مستوى التحدي وإدامة حالة الاشتباك وتطوير أدواتها، ومن الطبيعي أن يؤسس لمرحلة جديدة، وهذه المرحلة تحتاج أدوات جديدة يجب أن يقررها الشعب الفلسطيني عبر انتخابات شاملة لمنظمة التحرير والاتحادات والنقابات والروابط، لأن استمرار الأدوات القديمة دون تفويض شعبي هو إجهاض مبكر للفكرة، لأنه من غير الممكن أن تؤسس لمرحلة جديدة بتلك الأدوات السياسية والتنظيمية والكفاحية القديمة بعد أن أكدت التجربة عجزها، أو كانت جزءا من حالة العجز السياسي الذي أوصل الشعب الفلسطيني إلى ما هو فيه الآن، كون مل وصل إليه الواقع الفلسطيني في كل جوانبه هو نتيجة ممارسة سياسية وتنظيمية من تلك الأدوات وحاملها الحزبي، سواء من قبل حركة فتح التي تستحوذ على منظمة التحرير والسلطة في الضفة الغربية أو من قبل حركة حماس التي ارتكبت جريمة الانقلاب وفجرت المشهد الفلسطيني داخليا بكل تداعياته وبددت حالة الوحدة السياسية والجغرافية التي كانت قائمة رغم كل الملاحظات السلبية عليها، ليدفع الشعب ثمن خطايا وأخطاء تلك القوي سنوات ما بعد الانقلاب عام 2007ـ في البحث حول كيفية إعادة وصل ما انقطع، لتضيف تراكمات ممارسات الطرفين خلال تلك السنوات تعقيدا إضافيا جعل موضوع الوحدة محل سخرية أغلبية الشعب الفلسطيني وبعض قواه السياسية.
الترقيع السياسي
ولا مجال والحال هذه للهروب من هذا الاستحقاق بعملية الترقيع ومن نفس اللون السياسي (فتح) التي يجري التمهيد لها في دورة للمجلس المركزي، ستعقد في السادس من فبراير في غياب قوى أساسية، وهذا السلوك يعني أن الجهة المتنفذة في حركة فتح ليست لديها نوايا صادقة في إعادة الاعتبار الفعلي قولا وعملا لمنظمة التحرير كي تشمل الجميع، لمن يقبل بصحيح ميثاقها كي تكون ممثلا للكل الفلسطيني وأداته الكفاحية وليست “مزرعة خاصة لحركة فتح” للأسف، كون المنظمة في حالتها الراهنة لا تعكس الواقع السياسي ولا موازين القوى في المشهد الفلسطيني. وحتى يتحمل الجميع عبء العملية الكفاحية بكل مفرداتها ويحاسب على هذا الأساس من الشعب الذي يعيش حالة اشتباك مستمرة مع الاحتلال، يجب على حركة فتح، أن تعي أنه لا وحدة دون وجود القوى الأساسية الوطنية والديمقراطية والإسلامية في نسيج المنظمة، وأنه يكفي “تحايلا” من قبل الفئة المتنفذة في فتح ، بلجوئها لجمع بعض القوى التي ليس لها ثقلا سياسيا أو شعبيا لتكون “ديكورا”، كي تدعي أنها بوجود تلك القوى قد حققت الوحدة الوطنية.
ولذلك فإنه لم يعد مقبولا أو مستوعبا على الصعيد الشعبي الفلسطيني والعربي والعالمي أن تطلب الأطراف التي تقف وراء حالة الاهتراء السياسية الراهنة، الانتصار للقضية الفلسطينية في حين أن هذه الأطراف وراء الانقسام وتمنع من إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير كأداة كفاحية أن تنتصر على ذاتها وتغادر ذهنية أين أكون؟ إلى ذهنية كيف لنا جميعا أن نكون؟
وأعتقد أنه من هنا نبدأ..














